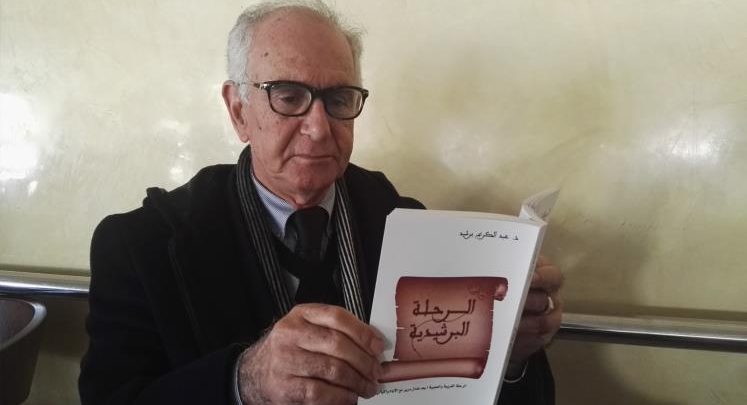تسألني الحروف حين يأتي الصباح، تسألني سواعد المدينة، تسكن في صدارة العين وتزيل هويتك وأنت تكتب في شرنقة الدورة الربيعية، تعشقك كل امرأة برية وكل طفل يركض خلف الضياء
2
تصالح كل الستائر والجالسين، تخرجنا من جفون النصوص، ومن دوائر المصابيح نراقب بسمتكم وأسئلتكم البارودية، حتى تحط فوق أعناقنا، فنتلذذ بالمواد والأجساد، وباللغات، والرقص الهامشي، وقبل الدخول في عوالم الكتابة العرضية، وقراءة الألواح، نقرأ فاتحة الجن والإنس حتى تستقيم مع عيوننا.
3
عشقنا اللغة الإيروسية، والشاعر الصداح (فريد)، والمخبر (خمار المريني، وصاحبه (العسري)، وكل الجوقة التي تصدح بلون العشاق، والإنارة تنشر ضلالها فيغدو هذا الجسد عناقا للجمهور، ورحلة لهذا الكائن من تيار إلى تيار، ومن شخصية إلى شخصية، يجعلنا العرض نحمل معاول التشييد لنبطل عبادة النص، ونبتعد من كل الأفاعي البرانية،
4
نلقى في هلوسات الجحيم، والأحلام، هدفنا إرغام هذه اللغة الإيحائية أن تولد لهذا الجسد المضاعف، بشاعريته وبنائيته، ففريد البوزيدي يخلق لنا لوحات أيقونية يتلذذ بها في الأحلام، وفي اللغة، والفلسفة، والشعر دون السقوط في صقيع الوحشة ودروب اليقين، كيف نساير كل التحولات التي تمسرح هذه الأجساد، وتكبر لحنها في شجر المتلقي البرغسوي، والفرويدي، من كل هذه الوصلات القرائية يحاول امبارك بدوره أن يوجه هذا الجسد المشخص، شاكيا أحرفا طازجة تكسر النحو، والصرف، وتعمل على تحرير النص من ثقوب التركيب النظمي أما البوهالي (عبد الله مفيد) ينشر الأخبار في وحل الداء، دون الدواء، يبتلع ريق المرارة فيبني أقساما في طابور كعاصمة طوباوية، وبهلوسات تخلق عرسا في الوجود، وتحت جنح الظلام، فتنم القوة الإنجازية برؤية تهتدي ولا تهدي بنا إلى أشرعة حلزونية، تقربنا إلى معمارية السؤال، من نحن وكيف نحن، ومن هم، وكيف هم؟
أما فريد البوزيدي بنرجسية يجترح لغة الصمت بأسئلة لا تضمد الجروح على ضفاف النص، بل تصعد عشق الليل نحو التاريخ العربي، وتضاريس الإنسان، والحرية، وتزاوج بين المقدس (الكتابة)، والمدنس الذي يطارده أينما حل وارتحل، فبالكتابة يطمئن حلمه، ويغاير المخبران (الخمار، والعسري) فهذان الأخيران لا يعرفان إلا لغة السطو وإيصال اللحن إلى القيثارة،
5
يسير الخمار، والعسري بموج واحد يرتبان الأسئلة، ويقولان لمن لا تاريخ له، يؤرخان للإنسان بميلاد كي يغوص في وجد المنسي، والمقصدي، يصطادان كل مروي، وغير مرئي، من أجل إرضاء الأسياد، وأصحاب الامتيازات، هكذا يضلان يراقبان الأحلام، والعبيد، وكل المحبضين الذين لفضتهم اللغة، واللعنة والخطيئة، أما نبيل بطوله يطلق كلاما ليرسم هذا الحلم الذي ينشر أوراقه في كل الأمكنة، يمحو أثر الماضي بعنجهية وأنافة عربية،
6
لكن التحول الإبستيمي كان هو شغل الشاعر عند المخرج “حميد الرضواني”، حيث أن هدفه هو إبراز الكيفية التي سيطبق بها رؤية في مجال التاريخ العربي، وكذا موقف بعض جهابذة التراث الديني الذي يحاربون كل تجديد، لأن تصدع الأوضاع الاجتماعية والثقافية سيشكل أرضية خصبة لبناء دوائر لا تشابهية، وكذا التسلسل اللازمني واللانهائي (أي بين ما تطرحه السماء، وما تنظمه الأرض، إذن يستحيل النسق الفكري بظهور هؤلاء الفقهاء والدراويش، وتقع المعرفة خارج الزمكان، وتتلمس المكان متسما بالغموض، والظلام، لأن هذه الجماعة تهرب من أكداس الثابت من أجل الالتجاء إلى المغاير، لأن إزالة الغشاوة على العين هي رؤية جديدة تفضي بنا لمعرفة المرئي على المقروء كما يقول زكريا إبراهيم في كتابه “مشكلة البنية” ص 143. إن عبد الله، وفريد، وامبارك، ونبيل يحاولون أن يزيلوا الستار على عصر يحتضر، ذلك لأنه يسجل سلبيات الواقع فمعه تتوقف الكلمة، ويمحى الإبداع ومعه ستنحل الرابطة القديمة بين التشابهات والعلامات كما يقول فوكو في كتابه الكلمات والأشياء ص 4.
– إن ما سار يملأ الركح في عالمنا، إنما هي ثقافة من نوع، تتأسس على قواعد وأسس معيارية، وترتكز على الخير والشر، وتنتظم في حدود الفكر الرجعي الظلامي، الذي يؤكد على انقطاعه عما قبله وعما بعده، فهذا الانقلاب المعرفي في الخطوط المعرفية وفي نظام القول والخطاب، حيث أن السلطة بنت على التمثل والإسناد، أما الشاعر فبنى جنسيته على الأثمان والنقد، وتحديد القيمة لهذا الليل، كل هذا في إطار اللوحات الكوليغرافية التي تتمفصل بين جنباتها الحية، وتتحدد خصائصها البنائية الرمزية، وتوزيعها اللغوي.
إن الخمار والعسري يحاولان أن يكشفا عن القواعد الابستيمية التي تسيج هذا الفضاء بزي يلبي نداء السلطة، إذن لا يمكن الحديث عن هذه الظاهرة إلا داخل التواريخ التي تتدرج في إطار دوران مغلق وتحت سيادة التشابه، واليقين المطلق، وهذه الرؤية عنده نتلمسها في اللغة وفي القيم واليوميات، والتقارير ويقول فوكو “إن تاريخ الكائن الحي إنما هو تاريخ لهذا الموجود الحي داخل الشبكة الدلالية التي تربط هذا الكائن بالعالم” نفس المرجع ص 141. إن هذا التقديم هو مجرد ملامسة سلطوية محدودة، لمفهوم الإشكال الذي يعيشه الكائن، باعتباره تقنية مرتبطة بالكتابة الركحية، وباللغة الدرامية التي تهدف إيجاد كيفية ما لبيان مهارة استخلاص هذا الفقر المتحجر، من ثم تسمح لنص بإسقاط لغة الحجر والوصاية التي ناد بها “الخمار المريني” مع اقتراح جذاذة كما نادت بها شيماء الباحذي للمراحل التي يمكن إتباعها للدفع بالبنت إلى إكساب هذه المهارة البسيطة، وذلك من أجل إعادة حالة الذات إلى شيء مفكر فيه، لأن العالم نسيج من الظواهر يستمد معناه من الذات الطبيعية وليس من المطلق أو الميتافيزيقية المركبة، فالذات الممسرحة “التي ناد بها الخمار المريني توصلنا إلى الذوات التي لا تعي كينونتها لا في التاريخ ولا في المجتمع، رغم أن التاريخ هو الزمن، وأن لغته خارج الصيرورة، وهبة من ذات عالية إلى ذات مرتبطة بموضوع وكوعي (الكل) لا ينفصل عن التصور والتمثل كما تقول الجيشطالتية)، فرفض كل نزعة ذرية هو اختزال للوعي الذي لا نظير له في عالم الأشياء، يرى من خلال الفكر الارتودوكسي الذي يجعلنا ندرك الخط الحواري البرغماتي الذي يغدو أن يكون موقفا تسويقيا للحالة المزرية التي عاشتها (شيماء)، وهذه الصورة المتطرفة جعلت الفكر السائد يمد ذراعيه إلى بعض الحقائق، لكي يستشف الأسباب الكامنة وراء اختفاء “الرجل” الخمار المريني في مكان، وزمان دون المشاورة ولا الحوار، وهذا الإقصاء حسب شيماء هو بحث عن لقمة العيش في زمان تنخره الديدان، وحراس “السلطة” ظلت تنتظر كودوا أن يأتي ولا يأتي، تستفيق على المواعيد من أجل اللقاء، والوصال، ولكن الوجد قد انصرم، وخار عزمها وانثنت على المسير، وأصبح الانتظار كمعتقد يواصل بينها في الليل، وحنين المنتظر الرسمي، لأن خصوصاتها ترمي إلى تصوير الثابت بحركة فاعلة، وكمحرك فاعل للأسرة، وكهيمنة لخيالها الذي لم ينزاح عن ذاكرتها، حتى ولو حدث هذا المحو، ظل الشاعر يصفها، وهي تتذكر مع ابنتها في ليل يهيم وينشر بسكونه الأبدي كبعد استعاري، ويرمي أيضا بأمواجه كل الدراويش، والمستضعفين إذن كيف نكتب التاريخ الليلي، ونحن لا نعترف بالثقافة ولا طرح الأسئلة؟ وكيف نبني الحقائق لنصنع منها مفردات لا نهائية؟ هكذا ظل فريد يعدد لنا جداول الأعمال الممكنة، ففعله يلتمس لنا “الغياب / والحضور والليل / والنهار، والحقيقة والخيال والموت / والحياة، والثابت والمتحول وذلك عبر بعدين أساسيين:
– بعد يعتمد التحدي للتاريخ الرسمي الذي يحاول أن يكون فاعلا أمثل وأشمل
– وبعد يجلب الطمأنينة المسيجة بالإحباط والقول المصطنع والذي يستطيع أن يراقب، ويعاقب.
وعبر هذين البعدين “المراقبة والعقاب، يظل الاختلاف ينسج براعته ضد القمع والمحو الفكري فالشخصيات حاولت الادعاء باسم الحقيقة داخل اللاحقيقة، والواقع داخل اللاواقع. الشيء الذي جعلنا ندرك هذا الموقع الذي لم ينفلت من التأريخ باسم القطيعة (الدراويش، النظارات، الانتهاء، الحفلة، التمرد، العصي، البصر، النساء، الجسد، الرغبة، اللذة).
فهذه التيمات تؤشر على شيء فعلي – المكانة – والغنيمة – التي يحتلها السؤال في درس الدراويش، سواء نظرنا إليه من منظور بسيط، أو من منظور نفسي، واجتماعي، باعتبار السؤال هو الدهشة النقدية لهذه الأجسام الكوليغرافية وذات الطلب والاستخبار. فالسائل دوما يرجو تحقيق رغبة ما، لأن الحواس والجوارح مرتبطة بالغرائز، وبالأجساد واللغة الإيحائية، وبالتصور، والتمثيل، وهو ما يعني أن طلب الموجود لا يكون إلا بالسؤال – كيف – ولماذا وبمن فهو سلوك وجودي لا ينفصل عن الوجود الإنساني، حسب مفهوم (ج سارتر). من هنا تبقى الإجابة عندهم مرتبطة بالوجود، وبالسؤال وباللغة، لأن وجود الجسد المتخيل لا يكون إلا في البصر، وليس البصيرة، وهذه المفارقة تميز كل سؤال من حيث هو كذلك ككفاية إدراكية، تفترض أن المتلقي مالك للخيال، ومحب للحكمة، ولكنه لا يمكن إلا أن يرتد إلى ذاته شاكا في كل الأجوبة المقدمة ما دام الأسئلة لا تفيد أي يقين، إذا لم تكن أنت شاكا في الضياء والظلمة كي يأخذ الجسد طبيعته التمفصلية وسمته المميزة، لأن الإنسان خالق لأدواته المعرفية، نظرا لكونها واسطة وجدلية تربط بين اللغة والكون، وهذه الجدلية هي الكتابة التي تعلن تحررها من كل قيد، أو تسلط كما عند فريد.
– إن الحوار الذي باشرته الشخصيات تظهر فيه النزعات الإنسانية كوجود عيني ملموس، في الهنا – والهناك، وهو ما يوجه تفكيرهم ووعيهم حيث تنتهي إلى موقف محدد، ولا يخفي أثر هذه المرجعية المنظورية التي ترسم الاتجاهات نحو قراءة الوعي الإنساني، وذلك من خلال التعرف على البنية الفكرية والبنية الضرورية اللازمة، إن الخمار المريني في تموجاته عمل على اجتياح الوعي الفردي للتحرر من الحدود بين الممارسة والدربة، والتجربة، فبالسلطة المعرفية، والرمزية، والمادية يحضر المنتظر المنتظر (الخمار) كحامل لكلام مقدس، لأنه هو الوسيلة التي تتحقق عبرها اللغة الدرامية، وينبهنا أيضا إلى العلاقة المؤسسة بين الطرفين التي هي تراتب أو بالأحرى علاقة قوة، يتصرف بها المتطرف الذي يعتقد أنه يملك تجربة ثقافية وأخلاقية هامة مغايرة على المجتمع ومن تم، فإن المتطرف وإذا كان ذا إزاحة ضعيفة فهو يقلد الآخر ويتخذه نموذجا، ولا يفوقه لأن العلاقة بين شيماء والخمار هي علاقة سلطة أخلاقية وعقدية، والخمار ليس سوى نائب عن سلطة عليا، هذه السلطة هي سلطة الفقيه، والمفتي، والظلامي والمثقف، وسلطة المجتمع بترسباته وقوانينه وأعرافه، بحيث لا تصح عملية التربية والتنشئة إلا بعملية نقل تعسفي لمعطيات المجتمع، يحضر الحوار مرة أخرى كلحظة في أفق تكسير حاجز هذه السلطة، وتحويل العلاقة من عنف رمزي إلى علاقة جدلية، وتعبير عن الذات، هذا التماثل بين هذه الآراء هي رؤية وجودية إنسانية تتأسس على التخصيص، بحيث نرى الموجود الممكن لأجل ذاته، حيثما يظهر لنا عندما يجعله فاقدا لذاته، فالإنسان هو منبع العدم فإنه لابد أن يكون حاملا للعدم في داخل ذاته (مارتن هيدجر).
وبناءا عليه، فالموجود “الممكن” لأجل ذاته يتميز بثلاث اتجاهات:
– عملية الوعي، والحرية
– ميله نحو الآخر
– ميله نحو المتسامي
فهذه العمليات “الوعي – الحرية – والقانون” هي عمليات وتغير الماهية، والكينونة، لأن العلة بالوعي الممكن هو نوع من الضغط الوجودي الذي يحرر الإنسان من كل الأنساق الفوقية ومن كل تبعية، ووصاية، فالمسرحية هي حكاية كاتب مسرحي كان أعمى فأصبح مبصرا ليجدد ذاتيته وسط أحياء المدينة التي تقتل أبناءها، وتجعله غريبا كصالح في ثمود، هكذا تكرالسبحة فيغذو الكاتب سائحا في دروب الكتابة، ناسجا مع خياله نصا مسرحيا “موال مسرحي” حيث يلتقي بشخصيات في الليل الساكن، فيحاورها وتحاوره، ويعيش انتظاراتها ورقصاتها وأسمائها إلى درجة أن يشكك في هويتها، وفي اسمه، لذا يسقط ضحية لعبة الأسماء الماكرة، حيث تفردت بأسئلة مست المجال السوسيوثقافي بالنسبة إليه، حيث أصبحت هذه الأسماء قوة مادية ماكرة، تبني عالما صنع جماهير منمطة التي تجسدها الصافية، وابن هدي العائد من ديار الغربة بأساليب مصنوعة وغير طبيعية.
فهذه الأفكار هي رغبة في البحث عن مكونات وماورائيات الذات، إنها ثورة ضد جوقة العميان، ودرهمان المتسول ومعروف والمفضل، وكل خطاب الذي يريد أن يتأسس بواسطة الكتابة الركحية، فهي التي تثبت الكون عبر الرمز، لأن الانتقال من القوة إلى الفعل، هو انتقال يتم بواسطة المتلقي، فالعالم كتاب مفتوح يريد تغيير وعيه بواسطة تواجد شخصيتين اللتين تراقبان ما يدور في الساحات من طرف رواد الملاهي، والمطاعم التي تعيش الدلالات والإيقاعات الرمزية، إنها إيحاءات تخترق المجاورة وكل طبقات الذاكرة والتاريخ، وتعمل الشخصيات على تحريك الأرضية الصلبة لتحويل موادها الفكرية ومعارفها الأصلية، وهي عتبة نقدية تفتح الأعماق وتلغي الأوهام بلغة باثولوجية تصبو إلى إيجاد تقنية علاجية، وتشخيص جواني لتأسيس واقع جديد بكل مؤسساته، ومراكزه لكي يشتبك مع أسئلة الحاضر، وبخاصة سؤال الحوار الإنساني، الذي يسقى بماء الخيال، والحرية والتعبير الديمقراطي، فالمخرج يريد أن يستثمر مفارقة الحياة وبطبقها على الواقع، والأدب، والفكر، لكي يظل المحتمل هو المتنوع، والحقيقة، والإرادة المعرفية، فالمسرحية ليست استمتاع بالخطاب المستعار، بل هو ممارسة ركحية تقترح صيغا وبراديكما أخلاقيا وجماليا، يقدم حلولا تاريخيا يعمل في صلب الراهن فكرا وممارسة، ويبين فوكو “حماقتهم القائمة في اعتقادهم، حيث أن كل فكر يعبر عن إيديولوجية طبقية وهم لا يرون أن الفكر في درجته الصفر، من الكتابة ص 24 والمعرفة والسلطة ص 124 – ويقول الشاعر في هذا الصدد:
أنا ما كنت أعمى إلا يوم كان العمى موضة ولكنه أصبح فكرة، وحرام علي أن أغمض عيني وأنام لهذا جئت الليلة هذا الحي لأنه حي الساهرين والأحياء وليس للأموت.
سكون هذا الليل يغري بالكتابة ودروب هذا الحي يغري بالتسكع ولابد من لحظة التأمل، وفما أروع هذا الليل إنه يبهج العين ويريح الروح
عندما كنت أعمى لم يعطوني إلا لونا واحدا، قالوا لي، ليس في الحياة والطبيعة والمدن والقرى، إلا هذا اللون واليوم اكتشفت الأصباغ والأشكال وأعرف أنهم كانوا كاذبين.
ما أجمل هذا الليل إنه مثلى سلطان متوج، وهذا القمر الذي في السماء كتاج مرصع بالياقوت والمرجان وهو تاجي، وتاج كل الشعراء والمثقفين، والمتسكعين وهذه النظرات، إنها تضايقني، وهذه العصا لماذا ترافقني دائما، أنا لست بحاجة إليها ذات مساء خرج الليل سائرا على أهل المدينة، سلاح لم يعرفوه قط، ذبح أحلامهم، وحمل نساءهم في عربة مظلمة، حين استيقظ الرجال – غضبوا وبللت دموعهم أقدامهم، وانتظروا أن على الليل فيطلبون الثأر هكذا مات الأجداد في الليل.
دون أجراس أو عويل كانوا نائمين نائمين كانوا
هذا الليل ليس أسود ولكنه رمادي وليس لونا، واحدا، ولكنه لونان منسجمان في الطبيعة والحياة، وعشقهما ليس كمثله شيء، هو سواد في بياض، أو بياض في سواد لعبة الأسماء ماكر معه احذروها واعباد الله واحذروا أقنعتها هكذا تكلم مجدوب المدينة، هكذا عملت المسرحية على توظيف أبعاد جمالية وإيقاعية جسدية، ولغوية مما أعطى لها منحنا تاريخيا مقاوما للساكن، ورحلة في الوجود برؤية بصرية تؤثث المسامع، وتثري القلوب إنها ثورة فكرية وجمالية، ونسق يجمع بين الهنا والآن، والآتي.
إنجاز الدكتور إنجاز
الغزيوي بوعلي بن المدني ليلة
فاس